مع أن عملية تدمر التي قُتل فيها جنديان ومترجم أميركيون، وأصيب ثلاثة آخرون، محدودة، قام بها فرد، وقد يكون ذئباً منفرداً أو مرتبطاً بشكل وثيق بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي، لكنّها تشكّل واحداً من أقسى الاختبارات التي تعرّضت لها الدولة السورية الجديدة، فقد جاءت بعد أن نجحت الدولة، خلال عام، في نقل سورية من بلدٍ معادٍ تاريخياً للولايات المتحدة إلى بلدٍ حليفٍ لها، وبعد أيّام من قرار الكونغرس الأميركي رفع عقوبات قانون قيصر. وتجلّى العداء للولايات المتحدة في تصنيف هيئة تحرير الشام تنظيماً إرهابياً، ووضع مكافآت للقبض على زعيمها، الرئيس السوري حالياً، أحمد الشرع، باعتبارها امتداداً لتنظيم القاعدة الذي دخل في حرب مفتوحة مع الولايات المتحدة منذ منتصف التسعينيّات. وقبل ذلك، بنى حزب البعث نظاماً راديكالياً معادياً للولايات المتحدة، متحالفاً مع الاتحاد السوفييتي ثم روسيا وإيران.
أحدث الاعتداء ارتباكاً متوقّعاً؛ إذ تراوحت التصريحات الرسمية بين الإنكار والاستنكار: إنكار أن يكون الفاعل عضواً في جهاز الأمن، واستنكاراً لفعله. والواقع أن هذا الاختبار، مثل أي اختبار، قد تنجح فيه الدولة وتتفوّق، وقد ترسب فيه. يشكّل “داعش” وذيوله الفكرية والأمنية والعسكرية واحداً من التحدّيات التي تهدّد سورية دولة ومجتمعاً، وهي تتغذّى من رواسب فكرية وتنظيمية قديمة، وروافد جديدة تتجلّى في الإخفاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
لقد نجح أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع لاحقاً) في اختبار أكثر صعوبة عندما واجه “داعش” في البدايات، وكانت أكثر عدداً وعدّة وشرعية. فالذين كانوا يقاتلون في صفوف جبهة النصرة بايعوه على الموت من أجل خلافة على منهج النبوة والجهاد، من دون اعترافٍ بحدود الدولة القُطرية، ولم تكن الفروق الفكرية والسياسية والتنظيمية واضحة بينهما. من أبرز ملامح الانقسام بين جبهة النصرة و”داعش” كانت عملية اغتيال أبي خالد السوري، أحد مؤسّسي حركة أحرار الشام، وشكّل نموذجاً لتحوّلات الشباب السوري من الاعتدال إلى الجهاد ثم العودة إلى الاعتدال. فهو من جيل الثمانينيّات الذي نشأ في دعوة الإخوان المسلمين، التي كانت حركة تربوية إحيائية سياسية، وبعد انقلاب “البعث” تحوّلت جهادية، من خلال “الطليعة المقاتلة” لجماعة الإخوان المسلمين، التي اعتبرت أن مواجهة انقلاب “البعث” تكون بالأدوات العنفية نفسها، لا بالأدوات السلمية. غادر أبو خالد السوري بعد هزيمة الثورة المسلحة إلى أفغانستان، وهناك، على الرغم من هزيمة الاتحاد السوفييتي، فشل مشروع بناء الدولة الأفغانية، وتحوّل إلى “القاعدة” التي تمثّل حركة جهادية عالمية لا تعترف بالدول، ومساحتها العالم بأسره. شكّلت الثورة السورية فرصة للعودة إلى مشروع الحركة الإسلامية السورية الأول، وهو ما عبّرت عنه حركة أحرار الشام؛ فهذه تستخدم العنف ردّة فعل على عنف النظام، لا لإقامة دولة لطائفة، بل دولة لجميع السوريين. شكّل اغتيال أبي خالد السوري صدمة لدى الجهاديين، إذ تمكّن تنظيم داعش من تجنيد شابّ يفجّر نفسه في واحد من “أعلام الجهاد” بذريعة أنه مرتدّ. ولك أن تتخيّل: من ينجح في تجنيد شابّ يفجّر نفسه في زعيمٍ يجاهد قبل أن يُولَد، كيف سهل عليه أن يُجنّد شابّ لقتل قوات أميركية في سورية.
تشكّل عملية تدمر فرصة، ليس فقط لبناء الجهاز الأمني السوري، وهو من أسّس الدولة، وإنما لبناء الثقافة المجتمعية العامة على قيم الدولة والقانون، سواء كانت قوانين محلّية أم التزامات دولية. فالدولة تحتكر السلاح ولها وحدها شرعية استخدامه، أمر لا يجوز لأي طرف أن ينازع فيه. كما تشكّل العملية فرصة لدمج سورية مع العالم في محاربة التطرّف وأسبابه. فالعدوان الإسرائيلي، المدعوم من الولايات المتحدة، يُشكّل ذريعة منذ 11 سبتمبر (2001) للاعتداء على الأميركيين، عسكريين ومدنيين، وهذا يتطلّب كسب الرأي العام الأميركي في المعركة ضدّ الاحتلال، سواء احتلال الجولان أو الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد نجاح الثورة، فالسوري الذي قاتل 14 عاماً ثأراً لكرامته، يرى العدو الصهيوني ينتهك تراب بلاده يومياً، ويعلن خططه لتقسيمها، ويعيث فيها فتنة وفساداً، في السويداء وغيرها. ويرى، مثل شعوب العالم، المجزرة المفتوحة في غزّة، وذلك كلّه بسلاح أميركي، ودعم من واشنطن، وغضّ طرف في أحسن الأحوال.
لم تكن أول عملية يتعرّض لها الجنود الأميركيون من قوات حليفة، فالاعتداء أخيراً على البيت الأبيض نفّذه لاجئ شرعي أفغاني، سبق أن خدم متعاقداً مع قوات الأمن الأميركية، وقبلها شهدت الولايات المتحدة وحلفاؤها، خلال العقود الماضية، حوادث صادمة تمثّلت في إقدام جنود، يخدمون داخل جيوش حليفة أو في الجيش الأميركي نفسه، على إطلاق النار على جنود أميركيين؛ أحدهم الرقيب كوارنيليوس سامانترِيو رادفورد (28 عاماً)، في 6 أغسطس/ آب 2025، حين أطلق النار داخل قاعدة فورت ستيوارت في ولاية جورجيا، مستخدماً مسدساً شخصياً، وأسفر الهجوم عن إصابة خمسة جنود أميركيين. تمكّن زملاؤه من السيطرة عليه واعتقاله فوراً. وقبلها (نوفمبر/ تشرين الثاني 2009) نفّذ الضابط الأميركي، نضال مالك حسن، هجوماً داخل قاعدة فورت هود في ولاية تكساس، فأطلق النار على زملائه، ما أدّى إلى مقتل 13 جندياً وإصابة العشرات. اعتُبرت الحادثة من أعنف الهجمات الداخلية في تاريخ الجيش الأميركي، وحُكم على حسن بالإعدام بعد إدانته بتهم القتل العمد. وشهد الأردن (2016)، الحليف التاريخي عسكرياً وأمنياً للولايات المتحدة، إطلاق الجندي الأردني، معارك أبو تايه، النار على ثلاثة جنود أميركيين داخل قاعدة الملك فيصل الجوّية في منطقة الجفر بمحافظة معان…. تلك العمليات ضدّ الأميركيين لا تُقارن بالعمليات ضدّ السوريين، ولعلّ تفجير كنيسة مار إلياس نموذجٌ لمدى الإجرام الذي يمكن أن يصل إليه “داعش”، وكان ضمن المخطط وقتها اغتيال الرئيس أحمد الشرع الذي تعتبره عدوّها الأول.
لم تكن معركة الشرع مع “داعش” سهلة، ولم تكن مجرّد جولة عسكرية انتصرت فيها هيئة تحرير الشام والفصائل الحليفة على التنظيم، بقدر ما كانت صراعاً فكرياً بالغ التعقيد، ومواجهة يومية عبر محاولة تقديم نموذج (ولو محدود) لأداء الدولة خلال مرحلة إدلب. ويُسجَّل هنا دور كلٍّ من الشيخين عبد الرحيم عطون ومظهر الويس في المعالجة الشرعية، عبر تفكيك مقولات أبي محمّد المقدسي وغيره من منظّري الجهاد العالمي، والعمل على بلورة مفهوم “الجهاد المحلّي” الذي يحدّد الخصم في النظام المستبدّ، ويعرّف الدولة تعريفاً عملياً يراعي الهُويَّة والقيم الإسلامية، من دون الالتزام بالتعريفات الصارمة للتكفير أو الحاكمية. غير أن هذه المواجهة الفكرية لم تُحسم بشكل نهائي، إذ تخلّلتها تسوياتٌ أمنية، وكان معظم من جرى الحديث عن اعتقالهم في إدلب من المنتمين إلى جماعات جهادية مرتبطة بـ”داعش” أو المتأثرة بفكره. وقد كشفت أحداث الساحل لاحقاً أن بعض من أُطلق سراحهم ضمن تلك التسويات لعبوا دوراً تخريبياً كبيراً في نشر الفكر التكفيري، لا سيّما التحريض ضدّ العلويين على أساس طائفي. وأحد المُفرَج عنهم كان ممَّن رفع شعار “لا تستفتِ أحداً في قتل العلويين”، وبالمنهجية الفكرية نفسها: “لا تستفتِ أحداً في قتل الدروز والأميركيين، وبعدها (الطواغيت) من جند الشرع”.
خاضت الهيئة المعركة الداخلية مع التيارات المتشدّدة في سياق مشروع بناء الدولة، منذ كانت في إدلب، على نحو يشبه ما فعله الملك عبد العزيز آل سعود في معركة السبلة، حين واجه “إخوان من أطاع الله”، الذين خاضوا معارك الدعوة الوهابية، لكنّهم اصطدموا بمفهوم الدولة. ومثّلت تجربة إدلب تمريناً معقّداً على تغليب منطق الدولة على منطق الدعوة والثورة، مع كل ما رافق ذلك من تناقضات وتسويات.
المقارنة بين تجربة هيئة تحرير الشام، والانتقال من مرحلة الدعوة إلى محاولة بناء الدولة، مع ما قام به الملك عبد العزيز حين واجه “الإخوان” (مجموعة من المقاتلين الذين عُرفوا بهذا الاسم انطلاقاً من شعارهم “إخوان من أطاع الله”) لا تجافي الواقع، وقد تمكّن من الانتصار عليهم في معركة السبلة، التي شكّلت محطّة مفصلية في تثبيت أسس الدولة السعودية، والانتقال من منطق الدعوة والجماعة إلى منطق الدولة. وقد ظهر الخلاف بين عبد العزيز و”الإخوان” بوضوح عند دخوله جدّة، حين كانت المملكة الحجازية تعتمد على ضرائب التبغ في وقت كان “الإخوان” يُحرِّمونه. فكيف تعتمد دولة الشريعة على المُحرَّم؟ عند هذه النقطة تحديداً، برز التناقض بين الفهم الحرفي للدعوة ومتطلّبات إدارة الدولة.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن “الجولاني” (أحمد الشرع) سلك مساراً مشابهاً في إدلب ابتداءً، وهو اليوم يخوض المراحل النهائية من هذا الصراع لا بداياته. ولم تبرز في إدلب معارضة جوهرية لفكرة الدولة، سواء في ما يتعلّق بجمع الضرائب، أو بتنظيم مظاهر الحياة العامة التي لا تتعارض مع التعاليم الإسلامية، كما يجري تفسيرها محلّياً. وتكرّس ذلك عقب دخول دمشق. فلا تتوقّف وظيفة الدولة على جمع الضرائب؛ فهي تحمي حقّ المدخّن والمزارع والصانع، وهي تحافظ على المعاهدات الدولية التجارية، فضلاً عن السياسية والعسكرية والأمنية. تلك دروس وعاها أكثرية السوريين، وتطبّقها الدولة الجديدة، لكن في تدمر، ثمّة عنصر أمن لم يعِ الدرس، والمأمول ألا يكون كثر مثله.
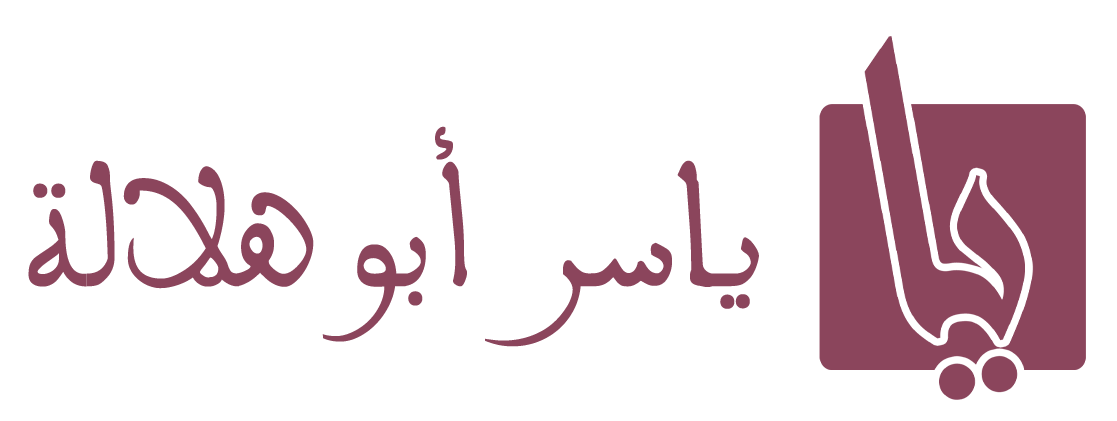





هل تريد التعليق؟